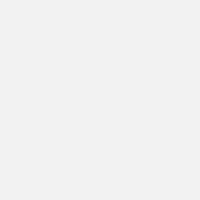لا حب في البراري: كيف شَوَّه علم النفس التطوري مفاهيمنا العاطفية
«ماذا تريد المرأة؟» و «ماذا يريد الرجل؟»؛ الأسئلة الرئيسية التي يطرحها علم النفس التطوري ليكشف لنا سرّ استراتيجيات التزاوج عند البشر. وهي أيضًا العناوين المثيرة لكتب تطوير الذات التي تَعِدك بكشف غموض الجنس الآخر. يغلبك حينها فضول المعرفة الممزوج بالاحتياج الأساسي للارتباط العاطفي، تسحب أحد هذه الكتب، وما إن تتصفحه حتى تنصدم بالأرقام والرسومات البيانية التي تدفعك إلى التأكد من عنوان الكتاب وموضوعه. تفتحه مجددًا، لتجد الصفحات تستعرض صُورًا زاعِمة بأنها «المرأة التي يُفضلها الرجال» و «الرجل الذي تُفضله النساء» كل هذا باسم علم النفس؛ لأن دراسة ما أجريت على مستخدميّ أحد تطبيقات المواعدة الأجنبية واستخلصت هذه النتيجة.
لكن القصة لا تنتهي بمجرد إعادتك للكتاب على الرفّ، لأن هناك مَن سيأتي من بعدك ويشتريه رَغبةً بكشف أسرار تَفضيلات النساء والرجال. سيقوم بتلخيص نتائج الكتاب وترجمتها، ثم مشاركتها على حساباته على مواقع التواصل عند كل متابعيه العرب، مُتجاهِلًا الفوارق الثقافية والاجتماعية عند العينات المدروسة. والآن، أصبحت هناك إجابات علموية مُبسَّطة ومنزوعة من سياقاتها تسبح في فضاء الانترنت؛ إجابات مُعلَّبة ومُبرَّدة تزعم معرفة سبب انجذاب المرأة إلى أموال الرجل، وانجذاب الرجل إلى جسد المرأة.
الإشكال هنا، يكمن في استخدام هذه الأجوبة كدليلٍ علمي على انحيازاتٍ فكرية مُسبقة عن الجنس والجنسانية فيما يتعلق بالجندر الذكوري والأنثوي، وهذا لأن في مجتمعاتنا المحافظة (حيث تنعدم التوعية الجنسية)، تكاد تكون معظم أفكار الشباب والشابات بالأمور الجنسانية مُستقاة من مصادر خارجية، فإما أن تكون مَغلوطة (كتأثير ما يُعرف بـ«النظرة الذكورية»، في الأفلام الإباحية)، أو غير مناسبة ثقافيًا بحكم الدين والمجتمع (كتطبيع الممارسات الجنسية العابرة).
أي إن اختزال نتائج دراسات علم النفس التطوري في مجموعة منشورات على مواقع التواصل، تجعل خلاصتها مُعرَّضة لتأويل القارىء بناءً على خلفيته الثقافية. وما يُقلِقُنا هنا، هو التأويل العلمي الخاطىء لتأكيد مفهوم جندري خاطىء؛ كأن يعتقد الشاب أنّ انجذاب المرأة إلى أموال الرجل يدل على خضوع الأنثى للذكر الـمُعيل، وتعتقد الشابة أنّ انجذاب الرجل إلى جسد المرأة يدل على أولوية إشباع الرغبة الجنسية عند الذكور.
فكيف لنا أن نتعامل مع نظرية التزاوج، ونتائج دراسات علم النفس التطوري في ظِلّ انفتاح مجتمعاتنا المحافظة على العوالم الرقمية للإنترنت؟
لكي نجيب على هذا السؤال .. علينا أولًا أن نفهم مبادىء علم النفس التطوري.
«الاصطِفاء الطبيعي» وآليات التأقلم
عندما نفكر بالطبيعة، تميل مخيلاتنا إلى التصور الرومانسي للغابات والبحار والبراري؛ خُضرة الشجر و زُرقة المحيط و لَمعة رمال الكثبان الرملية؛ صوت تساقط الأمطار، وتلاطم الأمواج وسكون سماء الصحاري الـمُرصّعة بالنجوم. كل هذه التصورات تُرَسّخ في أذهاننا مفهوم أمومة الطبيعة بدلالتها الدافئة، حيث تمدنا بوسائل الاسترخاء والتأمل، وتعيدنا إلى أصالة كوكبنا الغني والمتنوع.
لكن العلوم التطورية المبنية على نظرية «الاصطفاء الطبيعي Natural Selection» لديها تصور مختلف عن الطبيعة وأثرها على الإنسان قديمًا وحديثًا؛ فالطبيعة من منظور التطور باردة وبلا مشاعر. دائمًا ما تدفع أبناءها إلى حافة الهلاك، فلا يبقى منهم إلا مَن تأقلم وتطور ليتعايش مع مخاطر بيئته.
ومن الأمثلة على عملية «الاصطِفاء الطبيعي» وتَشَكُّل آليات التأقلم، فرضيات «تطور استِجابة الشعور بالخوف» التي تزعم فيها الدراسات، أن الخطر البيئي لسُمّيّة لدغات الأفاعي تسبب في تطور أدمغتنا وقدرات إدراكنا البصري، مما أدى إلى حمايتنا من تهديدها لبقائنا وتكاثرنا. والنتيجة هي استِجابتنا الحذِرة والسريعة لمجرد رؤية الأفعى أو سَماع فحيحها. أي أن الخوف من الأفاعي هو آلية نفسية تطورت لحلّ مشكلةٍ بيئية واجهت أسلاف البشر قبل ملايين السنوات، ولأن مَن يتأقلم ويتطور يكون هو الأصلح والقادر على البقاء والتكاثر، تنتقل آلياته بالتوارث الجيني عبر أجيال العصور المتتالية؛ فالإنسان الحديث يخاف منظر الأفعى أكثر من الأسلحة التي قد تهدد حياته في البيئة العصريّة، وهذا لأنه وَرَثَ الاستِجابة كآلية دفاع متأصلة فيه بالرغم من اختلاف العصور ومخاطرها.
وفي ذات الصدد يقول عالم النفس التطوري ديڤيد باس David Buss: «نحن نحمل آليات التأقلم التي أدّت إلى نجاة أسلافنا». بمعنى، أن الآليات المختلفة التي نتوارثها جينيًا، هي في أصلها حلول ناجحة لمشاكل بيئية في عصور سابقة. ومن هذا المنطلق، يسعى مجال علم النفس التطوري إلى كشف الأصول السببية وراء تطور الآليات النفسية التي يحملها الإنسان؛ وبذلك يؤسس قاعدة علمية تقوم عليها تفسيرات دوافع السلوك البشري، من الشعور بالغيرة حتى القتل المتعمد.
من هنا، تتضح لنا مَلامح الموقف العلموي للعلوم التطورية، وتحديدًا علم النفس التطوري، الذي يزعم إمكانية كشف سِرّ الطبيعة البشرية من تركيبتها البيولوجية. وفي هذا السياق، لا نستغرب مركزية سؤال التفضيلات، لأن عالِم النفس التطوري هو الوحيد الذي يملك الجرأة على طرح هذه الأسئلة ثم محاولة الإجابة عليها علميًا بالأرقام والرسومات البيانية.
الآن، لنتعمق أكثر في نظرية الانتقاء الجنسي ونرى كيف تَوَصل العلم النفس التطوري لنتائج تفضيلات المرأة والرجل.
نظرية «استثمار الوالِدَين»
في كتابه المرجعي المخصص للدراسات الأكاديمية، افتتح باس فصول التزاوج و تفضيلات الجنسين بتأسيس ينطلق من نظرية «استثمار الوالِدَين Parental Investment» لروبرت تريڤرز Robert Trivers؛ وهي نظرية تقوم على فرضيات مفادها أنّ الجنس صاحب الاستثمار الأكبر في عملية التكاثر (حجم الـمَشيج، حصرية الحمل، مَشقة الولادة، وارتباط الرضاعة) يكسب حق انتقائية الشريك؛ في حين أنّ الجنس الآخر صاحب المشاركة الأقل، عليه أن يدخل في صِراعاتٍ مع أقرانه ليظفر بفرصة التزاوج. وقد دعّم تريڤرز وزملائه صِحة هذه الفرضيات من خلال عِدة دراسات أجريت على مختلف الكائنات الحية؛ حتى أصبحت وثائقيات عالم الحيوان لا تخلو من تصوير هذه الظاهرة التزاوجية عند الحشرات والطيور والثديات. وعلى هذا الأساس النظري المدعم بأدلة الملاحظة العلمية، بَنى باس فرضياته عن استراتيجيات التزاوج عند البشر كآلية تأقلم تطورت عبر العصور.
ماذا تريد المرأة؟
لأن أنثى الإنسان تستثمر في عملية التكاثر أكثر من الذكر – هي مَن تحمل الجنين لتسعة أشهر، ثمّ تكابد آلام الولادة وبعد ذلك ترتبط بترضيع طفلها لعدة سنوات – هذا منحها انتقائية أعلى في التزاوج طوال تاريخ التطور البشري، مما انعكس بدوره على تفضيلاتها كآلية نفسية تَشَكَّلت لحلّ المشاكل البيئية التي هددت حياتها أثناء فترة الحمل؛ أهمها الحماية وتوفير الموارد.
فالسردية التطورية دائمًا ما تطالبنا بتخيّل الأنثى قبل ملايين السنوات، وهي في شهرها الثامن عاجزة عن توفير الطعام وحماية نفسها من خطر الضواري. من هذا التصور، يزعم علماء النفس التطوري أنّ الوضع البيئي تسبب بتطور آلية نفسية عند الأنثى تدفع انتقائيتها إلى تفضيل الذكر صاحب الموارد الوفيرة والبُنية الجسمانية القوية، لأن هذا الذكر سيوفر لها كل ما تحتاجه أثناء حملها و ولادتها، ومن ثمَّ تحقّق هدف البقاء والتكاثر، وبحسب مبادىء الاصطِفاء الطبيعي المبنية على التوارث الجيني، يذهب علماء النفس التطوري إلى أن هذه التفضيلات أصبحت متأصلة في طبيعة النساء.
ويُفَصِّل باس في كُتُبه ودراساته، أن بحث المرأة عن الأمان في الشريك ينعكس على تفضيلها للصِفات المرتبطة بحلول مشاكلها البيئية، سواءً كانت الحلول مباشرة أو غير مباشرة. أي إن المرأة لا تفضل بالضرورة الرجل ثري، بل تفضل الأوضاع والصفات التي تؤدي إلى الثراء؛ كـالمكانة الاجتماعية، والطموح المهني؛ ولأن انقطاع توفير الموارد بعد مغادرة الذكر يمثّل مشكلة بيئية أخرى طورت المرأة تفضيلًا للرجل الذي يُظهر علامات الوفاء واستمرارية العطاء. كما أن تفضيلها للبُنية الجسمانية القوية انعكس على انجذابها لتمظهرات الذكورة؛ كـالطول، والتركيبة العضلية، ونبرة الصوت الخشنة.
وهناك عشرات الدراسات التي تستخلص أنّ انتقائية المرأة دفعتها إلى البحث عن التفاصيل النفسية والجسمانية الدالة على سَلامة جينات الرجل؛ كـالاستقرار العاطفي، وجاذبية ملامح الوجه. فالمرأة تَعي أن جينات شريكها تلعب دورًا أساسيًا في تحديد جودة حياة ذريتهما؛ فالرجل الذكي سيُورِّث ذكاءه، والرجل القوي سيُورِّث قوته.
ماذا يريد الرجل؟
في المقابل، يرسم علماء النفس التطوري صورةً مختلفة عن التحديات البيئية التي تهدد استمرارية النسل عند الذكور. وهي تحديات تتمحور حول الأنثى؛ وتحديدًا، خصوبة الأنثى. فالمكسب من وراء تنافسية الذكور ليس الظفر بالارتباط، وإنما الظفر بالتخصيب؛ مما يعطي دلالات الخصوبة قيمة مِعيارية أعلى عند اختيار الشريك.
ولأنّ الدلالات الفسيولوجية تَتَمظهر على جسد المرأة (كـآثار البلوغ على الخصائص الجنسية الثانوية)، تطورت آلية التأقلم النفسية عند الرجل لتفضيل هذه التمظهرات باعتبارها العلامات الدالة على إمكانية تخصيب المرأة، وتحقيق هدف التكاثر. أيّ إن انجذاب الرجل إلى جسد المرأة يُفَسَّر – من المنظور التطوري – على أنه انجذاب لخصوبة الجسد لا جنسانيته؛ لأن آلية البحث عن علامات الخصوبة هي التي كفلت استمرارية أسلاف البشر.
من هنا، يربط باس ما بين دلالات الخصوبة ومعايير الجمال؛ بحيث تكون الصفة الدالة على خصوبة المرأة معيارًا جماليًا يجذب الرجل إليها. ويذهب إلى القول بكَونيّة هذه المعايير، لأنها مُتأصلة جينيًا في طبيعة الرجال؛ فـ(البشرة الصافية والشعر الغني الكثيف والشِفاه الممتلئة والخصر النحيل.. إلى آخره) تجذب جميع الرجال بغض النظر عن اختلافاتهم الشخصية والثقافية.
ويُحاجِج باس أيضًا، أن تفضيل الرجل للمرأة الشابة ينعكس على دلالة خصوبتها الفسيولوجية، فاحتمالية تخصيب المرأة تتراجع كلما تقدّم بها العمر، مما يقلل رغبة الرجال بها. وقد استخلصت عِدة دراسات عالمية صِحة هذه الفرضية، وأيَّدَت أنه بالرغم من التفاوت في تفضيل الفارق العمري بين الزوج و زوجته، إلا إن الرجال من كل ثقافات العالم يفضلون الزواج من امرأة أصغر منهم سِنًا.
الآن، وبعد استعراضٍ مقتضب لأهم فرضيات التزاوج عند البشر، نصل إلى خلاصة نظرية الانتقاء الجنسي، والتي يزعم فيها علماء النفس التطوري أنها ساهمت بشكلٍ أساسي في تَشكيل طبيعة الجنسين وعلاقتهما الديناميكية عبر سنواتٍ و سنوات من «التطور» و «التطور المقابل»؛ فعندما تطور المرأة تفضيلًا ما، يتطور الرجل على هذا الأساس لمنافسة أقرانه؛ وهكذا، حتى قِيل إنّ الرجال هم نتيجة تجربة تناسلية تجريها النساء.
إنها الرقصة التزاوجية الممتدة عبر تاريخنا البشري. فإن كانت طبيعة البشر قد تَشَكَّلت من جراء رقصة التزاوج بين أسلاف الإناث والذكور، هل يمكننا أن نعود إلى لحظة النغمة البدائية الأولى لنختبر صِحة فرضيات علم النفس التطوري؟
المرأة و الرجل في المجتمعات البدائية، دراسات مُثبتة أم حكايات مُختلقة؟
يكمل علماء النفس التطوري مشروع تركيب قِطَع فسيفساء الطبيعة البشرية عن طريق الدراسات الأنثروبولوجية الكاشِفة لأوضاع النساء والرجال في المجتمعات البدائية، وتحديدًا مجتمعات الصيد والجَني؛ حيث شَهَدَت البشرية أول تَقسيم للعمل بين الجنسين لتنظيم شؤون حياتهم، وتَشَكَّلت فيها الديناميكية الاجتماعية المؤديّة إلى خلق المؤثرات البيئية الدافِعة إلى تطور آليات التأقلم عند المرأة والرجل. فالقوة الجسمانية والنزعة العُنفيّة كمعطيات بيولوجية أساسية عند الرجال دفعتهم إلى الممارسات الخطيرة خارج حدود مساكنهم، كصيد الطرائد وحماية الجماعة؛ في حين ارتباط النساء بالرُضَّع والأطفال دفعهن إلى الممارسات الأقل خطورة داخل حدود المساكن وعلى أطرافها، كابتِكار الأدوات وجَني الثمار. ومن هذا التقسيم الوظيفي بين الجنسين على أسُس اختلافاتهم البيولوجية، ذهب بعض الباحثين إلى تأصيل مفهوم «الإعالة» في طبيعة الأب، ومفهوم «التربية» في طبيعة الأم؛ وبذلك، تكتسب التصورات التقليدية للأب الـمُعيل والأم الـمُربيّة شَرعيّةً علمية ممتدة منذ فجر التاريخ حسب التأويل التطوري.
تكمن أهمية هذه السياقات الأنثروبولوجية في كونها أساس قبول أو رفض فرضيات التطور المبنية عليها؛ بمعنى، لا يمكننا التسليم بصِحة فرضيات آليات التأقلم النفسية بالقياس على ما نلاحظه اليوم مِن سلوكيات، بل علينا أن نتتبّع ونتفحّص تناسق الآليات مع سرديتها التطورية الممتدة تاريخيًا. أي إن الأرقام الخرساء لنتائج دراسات علم النفس التطوري لا تُقيم حجة كشف سِرّ الطبيعة البشرية دون الاستناد إلى سردية تطورية متوافقة معها. فعلى سبيل المثال، لا يمكن استخلاص أصل انجذاب المرأة إلى أموال الرجل بأرقام الدراسات فقط، بل يجب أن تكون هناك سردية تطورية سانِدة لها، ومؤولة لنتائجها؛ وإلا أحلنا سردية اللامساواة الاقتصادية محلها، ونقول إنّ انجذاب المرأة إلى أموال الرجل هو نتيجة سنوات من اللامساواة في ظلّ النظام الأبوي، مما يُبطل فرضية تأصيل الانجذاب للماديات في طبيعة المرأة. وهذا ينطبق على كل فرضيات التفضيل التزاوجية عند الجنسين.
فإذا ما تَمعّنا في الحكايات الأنثروبولوجية لمجتمعات الصيد والجَني، سنجدها متعددة و متضاربة، ولا طبيعة ثابِتة لها؛ حتى لا يكاد الباحث أن يختار إحداها دون انحيازاتٍ فكرية تملأ الفراغات لتصوغ طبيعة الإنسان كما يريدها أن تكون. هناك دراسات تثبت الهيمنة الذكورية، وهناك دراسات تثبت الهيمنة الأنثوية، كما أن هناك دراسات تثبت المساواة بين الجنسين. هذا «اللّايقين Uncertainty» في الحكايات التاريخية يزعزع موضوعية العلوم التطورية ويضع فرضياتها على كف عفريت. وفي هذا الصدد، يقول شيروود واشبورن Sherwood Washburn – وهو أحد رواد الأنثروبولوجيا – أنه يفضل اعتبار إعادة تركيب التاريخ التطوري كـ«لعبة» أكثر من كونه «علمًا»، وهذا لاستحالة الوصول إلى «اليقين Certainty» في صحة فرضياتها.
إذن، إن كانت حكايات المجتمعات البدائية مَنقوصة إلى حدٍ لا تُمكّن عالِم النفس التطوري من إقامة حجته على أساسها، كيف استطاع أن يعيد صياغتها ليُرَوّج بها كشف طبيعة النساء والرجال؟
هذه الحكاية تبدو مألوفة، أين سمعتها من قبل؟
تخبرنا حكاية علم النفس التطوري أنه لا وجود للحُبّ في البراري؛ وأن تكلفة التطور يدفعها الرجل الفقير، والمرأة الـمُسِنّة، مما يشير ضمنيًا إلى أهمية حِيازة الموارد و تملّك السلطة في تطور النوع البشري والحضارة الإنسانية. فنجد كتب تطوير الذات المستندة على دراسات علم النفس التطوري تُطالب الجنسين بأمور مختلِفة؛ الرجل بأن يكون أقوى وأكثر تنافسية، و المرأة بأن تكون أنعم وأكثر إثارة؛ لأن تَبَنّي هذه الصفات تضمن للرجل الثراء، فيما تضمن للمرأة الجمال، ومن ثمَّ تضمن لهما النجاح!
هذه الحكاية الـمادية والـمُفرَّغَة من العاطفة تبدو مألوفة إلى حدٍ مريب؛ أليست هذه السردية الرأسمالية للطبيعة البشرية؟
فقد سبق وذكرنا أن قصور حكايات المجتمعات البدائية تدفع الباحث إلى تَدعّيمها بسردياتٍ عَصريةٍ مُنحازة، مما يحولها إلى أدلة مفبركة تثبت شَرعيّة توجهات الباحث الفكرية تحت مسمى: «الطبيعة التطورية للإنسان». فإن كان الباحث يؤمن بالقِيَم الرأسمالية، أصبحت طبيعة الإنسان رأسمالية. وهذا ما يقصده الكاتب الأمريكي لويس ميناند Louis Menand، حين وصف علم النفس التطوري بأنه “فلسفة للمنتصرين”، حيث يمكن استخدامه لشَرعَّنة أيّ نتيجة.
ولكي نثبت هذه المسألة، علينا أولًا أن نَتَفحَّص أوجه التشابه بين:
السردية الأنثروبولوجية في المجتمعات البدائية الأولى، كما هي مذكورة في الكتب المرجعية لعلم النفس التطوري.
السردية الرأسمالية في المجتمعات الصناعية الأولى، كما هي مذكورة في الدراسات الاجتماعية لما بعد الثورة الصناعية.
الأب الـمُعيل
يخرج الأب من مسكنه قبل شروق الشمس مُتجِهًا إلى الغابة، ولا يعود إلى أسرته إلا منتصف النهار حامِلًا فريسته الضخمة والدامية على كتفه.
يخرج الأب من منزله قبل شروق الشمس مُتجِهًا إلى المصنع خارج المدينة، ولا يعود إلى أسرته إلا منتصف النهار حامِلًا مؤونتهم و حاجِياتهم.
الأم الـمُرَبيّة
تقضي الأم يومها في حدود مسكنها، تهتم بأطفالها وتدبر شؤونهم وتشارك في أعمال البستنة.
تقضي الأم يومها في منزلها، تهتم بأطفالها وتدبر شؤونهم وتشارك في أعمال صِناعة النسيج.
هذا التشابه السردي الممتد عبر العصور، هو ما يستدل به الباحث التطوري على كشف طبيعة الأدوار الجندرية للرجال والنساء. أيّ إنه يرى في الجندرة قيمة بيولوجية متأصلة في كل رجل وامرأة قبل أن تكون مُركبًا اجتماعيًا تؤثر عليه الثقافة. ويقول إن هذه هي طبيعة الجنسين كما شَكَّلها الاصطفاء الطبيعي، وليس النظام الأبوي أو الرأسمالي، أو الثقافة الاستهلاكية والإعلام الغربي؛ ويُحاجِج على ذلك نظريًا بالأسبقية التاريخية لسرديته الأنثروبولوجية. وبعبارةٍ أخرى، يستخدم الباحث التطوري منطق «البقاء للأصلح»، ليمرّر من خلاله قِيَم الرأسمالية بتأصيلها في طبيعة البشر، ومن ثمَّ يربط صحة فرضياته بنجاح النموذج الرأسمالي (الرجل الثري محاط بالنساء، والمرأة المثيرة محاطة بالرجال). إذن، ما الرسالة الصريحة التي يوجهها علم النفس التطوري لشباب والشابات؟ " كونوا أثرياء واستهلكوا مستحضرات التجميل، فلا أحد يحبّ الفقراء والقبيحين"، هذه الرسالة بنبرتها الساخرة اللاذعة يمكن لها أن تنتمي إلى صفحات رواية «السايكوباث الأمريكي»، ولا عجب في ذلك، لأنها رواية كُتِبت لتصور جنون الثقافة الاستهلاكية وخواء العاطفة في ظلّ النظام الرأسمالي.
هنا، وكما ذكرنا في الجزئية السابقة، يقع الباحِث في فخ الانحياز الفكري؛ فما الذي دفعه إلى اختيار هذه السردية الأنثروبولوجية دون غيرها؟ ببساطة، لأن هذه السردية الوحيدة التي تتوافق مع التركيبة الاجتماعية وتحافظ عليها. فدراسات علم النفس التطوري هي الغطاء العلمي الذي يُشَرّعن أوضاع الجنسين في المجتمع ويبرّر الصور النمطية للإناث والذكور.
ففي كتابها «نشأة النظام الأبوي»، تلخص المؤرخة غيردا ليرنر Gerda Lerner كل ما ذكرته بقولها:
وحين هيمنت النظرية الداروينية على الفكر التاريخي، تَمّ النظر إلى ما قبل التاريخ على أنه مرحلة «بربرية» في التقدّم النشوئي للبشرية من الأبسط إلى الأكثر تعقيدًا. فما نجح و بقيَ حيًا اعتبر متفوقًا على ما تلاشى .. وطالما أن الافتراضات المتمركزة ذكوريًا هيمنت على تفسيراتنا، فقد قرأنا ترتيبات الجنس السائدة في الحاضر نحو الخلف في الماضي
وهذا يكشف لنا سبب تَيَقُّن الباحث التطوري من صِحة فرضياته؛ إنه يعيد تركيب سردياته من الحاضر إلى الماضي، ثم يخبرنا إنّ هذه طبيعة البشر منذ فجر التاريخ!
الآن، وبعد إزاحتنا للسردية الأنثروبولوجية لأوضاع النساء والرجال في المجتمعات البدائية الأولى، تتبقى لنا حكاية المجتمع الصناعي باعتبارها نقطة تَشَكُّل الأدوار الجندرية التي ينطلق منها الباحث التطوري إلى الماضي. فالثورة الصناعية أعادت تشكيل مفاهيم الأنوثة والذكورة بناءً على متطلبات العالم الجديد؛ عالم رأسمالي، حاول علم النفس التطوري أن يخفيه تحت ظِلال الطبيعة البشرية.
كيف أعادت الثورة الصناعية تشكيل الصور النمطية للنساء والرجال؟
في القرن الزمني الممتد من أواخر القرن الثامن عشر وإلى أواخر القرن التاسع عشر، طال التحول الصناعي الكثير من القِطاعات في أوروبا، والتي بدورها استَحدَثَت العديد من الوظائف داخل المصانع وخارجها، في نفس الوقت التي قضت فيه على الأعمال العائلية الصغرى المنافسة في السوق، مما دفع الرجال لمغادرة منازلهم من أجل اغتِنام الفُرَص وتحصيل لقمة العَيْش في هذا العالم المتجدد. إذْ إن النظام الرأسمالي في هذه المرحلة الثورية، قد شجع الرجال على التَحَلّي بالصفات التي تضمن نَجَاتهم في مَناجم الفحم و غابات المعادن، مثل الانضباطية والإنتاجية والإتقان، والخوض في المنافسات الدافعة للتطور الاقتصادي في المجتمع. ومع تَشَكُّل هذه البيئة الرأسمالية التنافسية، أصبح لِزامًا على رجال العَصر الفكتوري أن يصلبوا معايير الذكورة الأرستقراطية التي ورِّثَت لهم من العصر الجورجي؛حيث كان الرجال لا يوارون عاطِفتهم وكشف تعَرضِيّاتهم مثلهم مثل النساء، إلا إن هذا الاعتقاد لم يعد مقبولًا على الرجال في زمن التنافس الرأسمالي؛ إذ كانت العاطفة تدل على الضعف، والضعف يؤدي إلى الخسارة.
وانعكس هذا التحول الثوري على بُنية الأسرة مفهومًا و قِيمًا، و أعيد تشكيل الأدوار الزوجية على أساس متطلبات ومتغيرات المجتمع الرأسمالي. فمع خروج الزوج للعمل، وجدت الزوجة نفسها مضطرة للبقاء في المنزل لتَدبير شُؤونه من تربية الأبناء، وإدارة الأعمال العائلية أو ما تَبَقّى منها مثل صِناعة النَسيج. هذا التغير في الدور الأبوي داخل العائلة بعد خروجه من المنزل وانتقال سلطته الداخلية إلى الأم – وإن كان بصورة مؤقتة أمام الأبناء – دفع رجال القرن التاسع عشر إلى إعادة تعريف الذكورية بشكلٍ يضمن بقاء سُلطة النظام الأبوي في ظلّ تهديد التغيرات الاجتماعية.
وهذا ما حدث في بدايات القرن مع مفهوم «إعالة الأسرة» الذي تَرَسَّخَ مفاهيميًا وبشكلٍ أعمق مما كان عليه سابِقًا في دور الأب الـمُعيل. إذ استبدلت الثورة الصِناعية الحاجة للمَهارة اليدوية عند العمال والتي أتقنها كِلا الجنسين بقدرٍ متساوي، إلى الحاجة للقوة الجسدية في التعامل مع الآلات الثقيلة والعمل في الموانىء والمناجم ومواقع البِناء. وأصبح المتطلب الجسدي الأساسي لأداء الأعمال الثقيلة متجاوِزًا حدود الفروق الجندرية البيولوجية بين الرجل والمرأة إلى الفروق الجيلية أيضًا، حيث كان يتم إبعاد كِبار السن الخائِرة قواهم، وإقحام الفتيان في العمل مبكرًا. وقد كان لهذا التحول في مراهقة العصر الصناعيّ تأثيرًا تربويًا في التَنشِئَة على أساس الصورة الجندرية النمطية للذكر والأنثى، بإعداد الفتى من صغره لدور الأب الـمُعيل، وإعداد البنت من صغرها لدور الأم الـمُرَبيّة، حتى طُبِعت هذه الصورة الأسرية المشبعة بالقيم الذكورية في مُخيلة العقل الغربي خلال سنوات «القرن البرجوازي». فما بدأ على أنه حاجة للقوة الجسدية في بداية القرن، تحول تدريجيًا إلى هيمنة ذكورية ميسوجينية على القطاعات المهنية والتعليمية مع نهايته. حيث دفع الرجال بسردية التفوق الذكوري العقلاني على حساب القصور الأنثوي العاطفي من أجل الحِفاظ على التراتيبية الجندرية للنظام الأبوي ضد الحركات الحقوقية النسوية التي برزت في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر.
وقد كان هذا الموقِف المعادي للحركة النسوية في هجومها على سلطة النظام الأبوي موقفًا سائدًا بين أطباء الأعصاب في القرن التاسع عشر. وهم مَن خرجوا مِن الطبقة الوسطى للمجتمع متأثرين بالقيم البرجوازية للمفاهيم الجندرية، حيث الصورة النمطية للمرأة العاطفية تتناسب مع وظيفتها الأمومية ولا أكثر؛ وأن العاطفة الغَلّابة هي عَلامة ضعف المرأة، التي فسّرها أطباء تلك الحِقبة على أنها قصور في نمو جهازها العصبي مقارنةً بالرجل.
هنا يتضح لنا التشابه بين طبيب الأعصاب في القرن التاسع عشر وعالِم النفس التطوري في القرن الواحد والعشرين؛ إنهم يعملون على تأصيل الأدوار الجندرية في طبيعة النساء والرجال، إما في أجهزتهم العصبية أو تركيباتهم الجينية، بحيث تتم شَرعنة تقسيم الأدوار على أساس الأصل البيولوجي للجنسين، وضمان استمرارية التركيبة الاجتماعية بما يخدم النظام الرأسمالي والثقافة الاستهلاكية.
فالشابة لا تولد بطبيعة مُنجذبة إلى الرجل الثري، وإنما تولد في مجتمع يربط حقوقها بالرجل الـمُعيل (الأب ثم الزوج). والشاب لا يولد بطبيعة مُنجذبة إلى صورة جسمانية محددة، وإنما يولد في مجتمع يربط معايير الجمال بهذه الصورة. إذن، إنها البيئة الثقافية، وليس التركيبة الجينية التي تحدد تفضيلات الشريك عند الفرد. وهذا ينقلنا من «اليقين» المعرفي المزعوم عند علم النفس التطوري، إلى «اللّايقين» الضبابي لتفضيلات الفردية الخاصة؛ أيّ التحول من صِياغة الإجابات «اليَقينيّة» .. (هذا ما تريده المرأة) إلى السؤال اللّايقينيّ .. (هل هذا ما تريده المرأة؟)
نقد الحتمية البيولوجية .. نحن لسنا مجرد هرمونات
في هذه المرحلة من المقالة، وبعد استفاضتنا في نقد أسس سرديات علم النفس التطوري، نؤكد على أن نقدنا للفرضيات لا يعني رفضها كليًا. فهناك فروقات بين الذكر والأنثى، لكن ما نرفضه، هو السرديات التأويلية حين تُأصِّل الفروق في طبيعة الجنسين بشكلٍ حتمي. أي إن الذكورة المرتبطة بالعنف، والأنوثة المرتبطة بالعاطفة، ليست نتيجة حتمية تقررها التركيبة البيولوجية للذكور والإناث، وإنما هي نتيجة تفاعل هذه التركيبة مع البيئة الثقافية المعززة للعنف الذكوري والعاطفة الأنثوية، مما يدل على أثر القوالب الجندرية في تشكيل ما يُزعم على أنه طبيعة الجنسين. وبالتالي، علينا أن نفكك هذه القوالب المصنوعة على أساس التقسيم الجندري (الأب الـمُعيل والأم الـمُرَبيّة)، وما يترتب على ذلك من لامساواة بحقوق النساء، ثم نعيد تركيبها على أساس المساواة الرافِضة للحتمية البيولوجية في الصورة النمطية للمرأة والرجل.
هذا سيُخولنا لعزل مفاهيم السلوكيات الحتمية المرتبطة بالجندر مثل: «الصبيان سيتصرفون كالصبيان»، ونقد تبريرات السلوك الطائش من الصبيان حين يُنظر له على أنه نتيجة تأثير هرمون التستوستيرون؛ فالهرمونات تؤثر على السلوك لكن ليس بصورة حتمية؛ بل إن الثقافة المجتمعية لـ«الصبيان سيتصرفون كالصبيان» هي المؤثر الأكبر في هذه المعادلة، لأن الشاب سيعتقد أن ديناميكية علاقته بالنساء قائمة على اندفاعيته الطائشة بسبب طبيعته الذكورية.
هذه العقلية تكتسب دافعها السلوكي من وهم «اليقين» بمعرفة ما تريده المرأة، وشعور «الاستحقاقية» بأن تنجذب إليه؛ إنه الخليط المفاهيمي الأكثر خطورة والدافع إلى سلوكيات التحرش.
تقبّل «اللاّيقين» وتخلّص من شعور «الاستحقاق»
تكمن أهمية تقبل اللاّيقين في كونه قوة مُثبِّطة لنزعة التأويل الحميمي/الجنسي في ديناميكية العلاقات بين الرجال والنساء. هذه النزعة النفسية الذكورية تدفع بعض الرجال إلى تأويل سلوكيات المرأة اللاّحميمية واللاّجنسية على أنها دعوة حميمية وجنسية. فابتسامتها ومحادثاتها الودية قد يتم تأويلها على أنها مبادرة عاطفية، مما يدفع الرجل إلى الإقدام على سلوكيات مؤذية كرمي الكلام الجريء ، ومشاركة الصور من دون موافقة مسبقة، والترصد … إلخ. هنا، يأتي دور «اللاّيقين» في هدم الدافع وراء سلوكيات التحرش. فعلى الرجال أن يتقبلوه ويتبنوا ثقافة السؤال وطلب «الموافقة Consent» للوصول إلى «اليقين»؛ في الوقت ذاته، عليهم أن يصارعوا شعور «الاستحقاقية» المورث لهم من الثقافة الذكورية. فالثراء والمكانة الاجتماعية والبُنية الجسمانية، وعداها من الصفات لا تمنح الرجل أن يكون مُستحِقًا لأيّ شيء من المرأة، وهذا ما يُولّد عند الرجل المنتشيّ باستحقاقيته شعورًا بالحنق قد يدفعه إلى إيذاء المرأة التي رفضته.
نحن نتكلم هنا عن ظاهرة سلوكية نراها تتكرّر أمامنا في الشوارع وعلى شبكات الإنترنت. إنها الإرث الفكري للثقافة الذكورية التي تساهلت في نقد دوافع التحرش المتجذرة في المفاهيم الجندرية؛ مفاهيم قد نجدها متخفية في دراسات علم النفس التطوري وفي كتب تزعم معرفة «ماذا تريد المرأة؟» و «ماذا يريد الرجل؟».