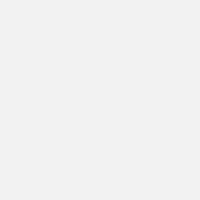فهم مواقع التواصل: امتدادات الإنسان في العالم الرقمي
أن تكتب مقالًا عن مواقع التواصل الاجتماعي في عصر التسارع التقني، يعني أن تحكم على كلمات هذا المقال وأفكاره بالإعدام؛ لأن ما تلاحظه وتكتب عنه اليوم، قد يتغير ويختفي غدًا. إنها مسألة وقت قبل أن يأتي تحديثًا داخليًّا (كإضافة خاصية القصص اليومية) أو تحولًا خارجيًّا (كصعود الخطابات الشعبوية) ليؤثر على تجاربنا في الخطوط الزمنية لمواقع التواصل. ومع تغير التجربة، يُعاد تشكيل استخدام الموقع، ليُصبح مُعززًا أو مُثبطًا لسلوكياتٍ محددة، مما يولد ظواهر جديدة تتطلب قراءةً مختلفة، ترفض ما كُتِب سابقًا وتُعيدنا إلى النقطة البداية. وما بين تأخر الكتابات الرصينة وسطحية الكتابات العَجلة، نجد أنفسنا عالقين في «لمبو الفضاء الافتراضي Cyberspace Limbo» من دون أدنى فهم لما يعنيه أن نكون هنا، بين العالمين الواقعي والرقمي.
إذن، ومِن وَسَط هذا اللمبو نسأل.. كيف لنا أن نفهم مواقع التواصل؟ وما الأدوات والمفاهيم الأساسية التي ستخولنا لذلك؟
مفهوم «امتدادات الإنسان»
هذا الفهم الجوهري الذي نسعى خلفه، هو ما حاول الوصول إليه الفيلسوف الكندي مارشل ماكلون Marshall McLuhan في كتابه الشهير «فهم وسائل الإعلام» في عام ١٩٦٤م. ونحن لا نتكلم هنا عن مقولته الخالدة «الوسيلة هي الرسالة» ولا عن مفهوم «القرية العالمية» التي تنبأ بها قبل ثورة مواقع التواصل، وإنما عن المنطلق الفلسفي الذي تبناه في تحليلاته والذي بَلَغَ من الأهمية بأن يكون العنوان الفرعي لكتابه الشهير .. ألا وهو مفهوم «امتدادات الإنسان The Extensions of Man».
فمن يقرأ لماكلون في يومنا الحاضر، سيجد كتاباته تلامس واقعنا من خلال هذا المفهوم تحديدًا؛ وهذا لأن «الامتدادات» كأداة مفاهيمية تقدم قراءةً تاريخية ممتدة عبر عصور التطور التقني؛ أي إن الإطار المفاهيمي الذي قدم من خلاله ماكلون قراءاته التحليلية لظواهر العصر الكهربائي، قادرٌ على العودة للماضي وتحليل الظواهر التقنية للعصر الصناعي، كما يمكنه القفز للمستقبل وتحليل الظواهر التقنية للعصر الرقمي، حيث يخبرنا في كتابه مِرارًا أن وسائل التقنية كلها – الحديثة و القديمة – هي امتدادات لوظائف جسد الإنسان؛ فالمذياع امتدادٌ لأسماعنا، والتلفاز امتدادٌ لأبصارنا، والسيارة امتدادٌ لأقدامنا. وعلى هذا المنوال، نرى إن الأجهزة الذكية امتدادٌ لأدمغتنا، والإنترنت امتدادٌ لعالمنا، حتى نصل إلى ذروة الامتدادات التقنية في كون النواقل المعلوماتية – كالألياف البصرية مثلًا – امتدادًا لأعصابنا؛ وبذلك تتم رَقْمَنَة الوعي البشري في امتداده في الفضاءات الافتراضية.
وقد تنبأ ماكلون بكل دقة وصولنا إلى هذه المرحلة حين قال:
في العصر الكهربائي، نرى أنفسنا وهي تُترجم أكثر فأكثر إلى الشكل المعلوماتي .. متحركين نحو الامتداد التقني للوعي.
خلل «الحتمية التقنية»
لا يسعنا أمام هذه الكلمات سوى الإقرار بأحقية لقب "رسول موجات الأثير" لمارشل ماكلون بدلًا من شخصية هاورد بيل في فلم «الشبكة – ١٩٧٦م»، وإن كان ماكلون أقلَّ غضبًا من بيل وأكثر اتزانًا منه، إلا أنه يتشارك معه النبوءات التشاؤمية فيما يُعرف بـ«الحتمية التقنية Technological Determinism». وهو التوجه الذي يؤمن بأن للأجهزة الإلكترونية الغَلَبة في التأثير على المستخدم، وأن تأثيرها غالبًا ما يكون سلبيًّا على الفرد والمجتمع. فنجد معظم دراسات «الحتمية التقنية» تتمركز حول تأثير الإنترنت على مفاهيمنا وسلوكنا وعلاقاتنا الاجتماعية، مع تهميشٍ لقيمة المحتوى المستهلَك أو السلوكيات الممارَسة. فإذا أظهرت نتائج دراسةٍ ما أننا نقضي أوقاتًا أطول على الأجهزة بدلًا من قراءة الكتب، هذا لا يعني بالضرورة استخدامنا للتقنية يقتصر على التسلية، بل قد يكون استخدامنا لها مُسَخَّرًا للتحصيل المعرفي كقراءة الكتب الإلكترونية!
وهنا يكمن خلل هذا التوجه، أنه يشيطن التقنية بتقديمها في إطارٍ سوداوي يُبرز سلبياتها على حساب إيجابياتها، وهذه إحدى تمظهرات قلق العصر الرقمي، الذي يقودنا إلى صميم الإشكالية الأخرى التي تعاني منها الكتابات عن مواقع التواصل .. وهي إشكالية النبرة.
إشكالية «النبرة القَلِقة»
هل يمكننا القول إن الإنترنت سيئٌ بالمطلق؟ هل يمكننا اعتبار مشكلات ألعاب الفيديو في مصاف الأزمات الكبرى التي تؤثر في جودة التربية والتعليم للجيل الناشئ؟ وهل يمكننا مقارنة الظواهر الاستهلاكية للتسوق الإلكتروني بما يمكن شِراؤه في الأعماق الإجرامية للويب؟ ببساطة، لا يمكننا ذلك؛ إذن، لماذا تصور لنا كتابات «الحتمية التقنية» واقعًا كارثيًا تقودنا فيه الأجهزة الإلكترونية إلى حافة الهاوية؟ تكمن إجابة هذا السؤال في مفهوم القلق؛ حيث تُعرفه كتب الطب النفسي بأنه:
استجابة لخطرٍ «غير معلوم» و «داخلي» و «غامض»
وفي حالة قلق العصر الرقمي، نجد أن هذه الاستجابة موجَّهةٌ نحو الإنترنت؛ أي إن مصدرَ التنظير المتوجس الذي يملأ كتابات الحتمية التقنية هو الشعورُ بالخطر مما هو غير معلوم وغامض بخصوص العالم الرقمي.
هذه «النبرة القَلِقة Anxious Tone»، تمثل لنا إشكالًا علينا تفكيكه وتجاوزه إذا ما أردنا أن نقدم قراءةً واقعية ومحايدة لمواقع التواصل؛ ولكي نقوم بذلك، علينا أولًا أن نتكلم عن الفوارق الجيليّة بين مستخدمي الإنترنت بناءً على مفهوم «المواطنة الرقمية Digital Citizenship».
الفرق ما بين «المهاجر الرقمي» و «المواطن الرقمي»
تُعد مسألة التصنيف الجيلي من المسائل الشائكة التي يصعب الإجماع عليها، وذلك لكون معايير التصنيف تستند إلى (الحالات الاجتماعية) و (العادات الثقافية) و (تحولات الأوضاع السياسية-الاقتصادية) في السياقات الزمانية المختلفة؛ مما يعني أن لكل منطقة تصنيفها الخاص بناءً على معاييرها الخاصة. لكن العالم الرقمي للإنترنت، أو القرية العالمية حسب تسمية ماكلون، لا يمكنها إلا أن تستند إلى وجودها كمعيار وحيد للتصنيف! أي إن ثورة مواقع التواصل هي النقطة المرجعية هنا، فتُصَنَّف الأجيال الرقمية إلى صنفين رئيسين، هما:
«المهاجرون Immigrants» : وهم مَن شَهِدوا التطور التقني والثورة التواصلية ثم هاجروا إلى عالمها ومواقعها (كمواليد الثمانينيات)
«المواطنون Natives» : وهم مَن وُلِدوا بين العالمين الواقعي والرقمي، فهم مستحقين للمواطنة الرقمية لأن هذا الشكل التواصلي هو كل ما يعرفونه (كمواليد الألفية).
ولنوضح المسألة أكثر، سأستعير اقتباسًا سينمائيًّا شهيرًا من فلم «صعود فارس الظلام – ٢٠١٢م»؛ حين أحاطت الظِلال بشخصية بين وقال مُخاطِبًا باتمان في العتمة:
أنت بالكاد تأقلمت مع الظلام. أنا ولِدت فيه، تَشَكَّلت به.
ففي سياقٍ مشابه منزوع من ثنائية الخير والشر، الغالب والمغلوب، كما في مواجهة بين وباتمان، نجد المواطن الرقمي يقول للمهاجر:
أنت بالكاد تأقلمت مع الإنترنت. أنا ولِدت فيه، تَشَكَّلت به.
هذه الجملة المستعارة، تكشف لنا عن الفارق الجوهري بين مستخدمي الإنترنت في عصرنا الحالي. فهناك جيلٌ كامل من المراهقين والمراهقات نشؤوا في العالم الرقمي وتَشَكّلوا به، في حين بقية الأجيال الأكبر سنًّا تحاول التأقلم معه بشكلٍ متفاوت. ومن هنا يتولد قلق العصر الرقمي عند الأجيال المهاجرة، إنه القلق من نتائج هذا التَشَكُّل على النشء؛ القلق من اضمحلال القيم والأخلاق، القلق من انتفاء الخصوصية، وغيرها من الكوابيس التي تهدد الفرد والمجتمع.
لكن ككل الكوابيس .. إنها مجرد مبالغة لشيء قد يكون ذا قيمة.
هل هناك ما يدعو للقلق؟ نعم و لا
بصياغةٍ أخرى نقول، إن «النبرة القَلِقة» لكتابات «الحتمية التقنية» التي تحذرنا من مخاطر الإنترنت، هي ضرب من المبالغات لإشكاليات موجودة فعلًا. لكن وجود الإشكال لا يبررها ولا يبرر تشاؤميتها؛ بل إن توجهها هذا، لا يُرجى منه تشخيصًا سليمًا لطبيعة الإشكال وكيفية علاجه. فلا يخفى على مستخدم الإنترنت أثره السلبي على الانتباه مثلًا، لكن ما الفائدة المرجوة من تصويره على أنه آفة العصر الحديث؟ فالنتيجة غالبًا ما تكون عكسية، تتوسع معها الفجوة بين الأجيال حتى تكاد تنعدم أي وسيلة للتواصل بينهم. هنا، نعود إلى مفهوم «الامتدادات» لنذكر بأن العالم الرقمي هو امتداد افتراضي لعالمنا الواقعي. والحقيقة التي لا مفر منها، هي أننا تجاوزنا «نقطة اللاعودة».
هذه حياتنا، والإنترنت جزءٌ لا يتجزأ منها، فتَشَكُّل الهُويات الثقافية والسياسية والجنسانية عند جيل بأكمله ستتم من خلال الإنترنت، مما يعني أن مسؤولياتِنا تجاه الجيل الناشئ أصبحت مُضاعفة، وهذا لا يعني بأي شكلٍ من الأشكال التضييق عليهم، بل ما نقصده هو أن المساحة التي يجب علينا أن نؤمِّنها لهم تضاعفت في الحجم بين العالمين الواقعي والرقمي.
التحذير من منزلق «التعيّر العمري»
تقع هذه المسؤولية الصعبة على عاتق (آخر الأجيال المهاجرة) و (أول الأجيال المواطنة)، لأن لديهم من القواسم المشتركة ما يُمكّنهم من التواصل بشكلٍ سليم وفعال؛ وبالتالي تحديد الهدف والوجهة. ومن المهم أن نوضح هنا، أن هذا ليس إقصاءً يحمل دلالات تعيّرية للأجيال الأكبر سنًّا، بقدر ما هو تعاونٌ خاصٌّ بين الأجيال الأكثر انغماسًا في العالم الرقمي. فالإنترنت هو ساحة لعب الشباب والشابات، ولا عيب في ذلك، هناك يتعرفون على أنفسهم وعلى الآخرين، يتنفسون شيئًا من الحرية وإن كانت افتراضية، إلا أنها تمثل ملاذًا لكثير ممن عصفت بهم قساوة الحياة. يضحكون ويبكون، يقعون في الحب ويتعرضون للتنمر، إنها ساحة لعب مفتوحة للجميع، لكن أغلب مرتاديها من الجيل الأصغر، لأن طبيعة الحياة تحتم علينا الرجوع إلى العالم الواقعي كلما كبرنا في العمر.
فالصور الساخرة والتحديات وغيرها من الفعاليات الرقمية لن تحافظ على قيمتها مع الوقت. ومفهوم «القيمة» في هذا السياق، هو المفهوم الأساس الذي تتمحور حوله أهمية التعاون الخاص بين (آخر الأجيال المهاجرة) و (أول الأجيال المواطنة)، لأن الإشكال المتعلق بقيمة ممارسة رقمية معينة، غالبًا تسخِّفها أو تُهوِّلها الأجيال الأكبر؛ فكيف لأشخاص لا يرون ما تراه الأجيال الشابة أن يُشخّصوا مشكلاتهم ويعالجوها؟
وبناءً على ما ذُكر حتى الآن، سنطرح مثالًا لممارسة رقمية تمس جميع المفاهيم التي ناقشناها بشكلٍ يكشف تعقيد الاختلافات بين الأجيال .. وهي مراسلة الصور الإيروتيكية عبر منصات التواصل الخاصة.
ونشدد قبل الخوض في المسألة، بأن التزامنا بالنبرة المحايدة في الطرح، لا تعني التشجيع على هذه الممارسة، كما أن اقتصارنا على جانب محدد، لا يقلل من أهمية بقية الجوانب المتعلقة بها؛ فننوّه إلى العودة للجوانب الدينية والثقافية والأمنية لأنها خارج نطاق تركيز المقالة.
قصدية الصورة الإيروتيكية وقيمتها الحميمية
في سياق المراسلات الخاصة، تعد الصورة الإيروتيكية عُملة ذات قيمة حميمية، تستخدم في التبادل العاطفي داخل علاقة ما بشكلها الافتراضي. ولا تكتسب هذه الصور قيمتها من كونها صورًا مثيرةً تستعرض مفاتن الجسد، بل لأنها امتدادًا افتراضيًّا لجنسانيته. فما يثير المتلقي ليس الجسد نفسه، وإنما وجوده في العقل المتجسد في الصورة أمامه. بمعنى، إن قصدية هذه الممارسة بامتدادها الجنساني (من المرسل إلى المتلقي) تعطي الصور الإيروتيكية شحنةً حميميةً تجعلها تملك قيمةً عاطفية أكبر؛ لكن، تبقى الممارسة رهينة افتراضيتها، بما في ذلك من إحباط جسدي لعدم إشباع الرغبة في الواقع.
ولأن الممارسات لا تحمل «القيمة» نفسها عند الأجيال المختلفة، نجد كبار المهاجرين في العالم الرقمي لا ينظرون إلى حميمية المراسلات الإيروتيكية كما ينظر إليها المواطنون الصغار، مما يخلق فجوةً مفاهيمية بين الجيلين تُعقّد من إمكانية التواصل بينهما. ففي حالات الاعتداء الرقمي كاختراق الأجهزة الإلكترونية وتسريب محتوياتها من محادثاتٍ وصورٍ خاصة، يذهب بعضهم إلى لوم الضحايا على ممارساتهم في الفضاء الافتراضي متجاهلين فظاعة المعتدي! وبذلك يتحول النقاش من أهمية العمل على حماية خصوصية المستخدم في الإنترنت، إلى ما إذا كان على الزوجة أن ترسل لزوجها صورة لبس نومها الجديد! وهذا ما يحدث حين لا يُتفق على «قيمة» الممارسة، فتصبح «القيمة» نفسها مركز الجدل بدلًا من الإشكاليات المتعلقة بها.
وبالعودة إلى ما ذكرناه سابقًا، نستطيع أن نستشف تأثير «الحتمية التقنية» على نظرة كبار المهاجرين فيما يتعلق بالمراسلات الإيروتيكية؛ وكما هو الحال دائمًا مع هذا التوجه، تفشل «نبرته القَلِقة» في تقديم صورة دقيقة للممارسة وتَشخيص إشكالياتها الفعلية. هذا ما يدفعنا إلى القول بأهمية التعاون بين (آخر الأجيال المهاجرة) و (أول الأجيال المواطنة)، لأنهم متجاوزون لجدل القيمة بحكم تقاربهم الجيلي والفكري. ولا نعني بالتجاوز هنا تجاوزًا لتطبيع الممارسة بالضرورة، فقد يكون تجاوزًا لنقدها، أو للتحذير منها؛ أي إنه تجاوز للوصول إلى نتيجة ما. وبصياغةٍ أخرى نقول، إن هذا التعاون الخاص بين الأجيال الشابة قادرٌ على التعامل مع تحديات العالم الرقمي إذا ما أُعطي الثقة ووفِّرت له الإمكانيات اللازمة لذلك.
إذن، وبعد إسهابنا في الحديث عن بعض الأدوات المفاهيمية المطلوبة لفهم مواقع التواصل، وربطها بالمراسلات الإيروتيكية كمثالٍ على ممارسة رقمية رائجة بين مستخدمي الإنترنت، حان الوقت لكي نسأل السؤال الأهم في هذه المقالة والذي سيرسم لنا الحد الفاصل بين العالمين الواقعي والرقمي .. ما طبيعة العلاقة بين الشيء وامتداده؟ فما الذي نقصده حين نقول إن صورة الجسد الإيروتيكية هي امتداد افتراضي لجنسانيته؟
أصالة الخبرة المتجسدة
لنمهد الإجابة عن السؤال بالحديث أولًا عن مصطلح «Extension ("اكستنشن")» في سياق حياتنا العصرية، والذي يدرج استخدامه في مجال تصفيفات الشعر، ويقصد به وصلات الشعر الخارجية التي تضفي على شعر الرأس طولًا وكثافة. هنا نقول: إن علاقة خصلة الشعر الخارجية بخصلة شعر الرأس علاقة امتداد غير متجسدة، أي إن خصلة الشعر الخارجية لا تنبت من فروة الرأس؛ وبالتالي هي أقلُّ أصالة، لأن ما هو أصيل هو بالضرورة متجسد.
وفي مثال المراسلات الإيروتيكية، نجد أنها علاقة امتداد قصدي لجنسانية المرسل بشكلها الافتراضي وغير المتجسد، مما يجعلها كممارسة حميمية أقلّ أصالةً من ناحية الخبرة وأقلّ إشباعًا من ناحية الرغبة، لأن من أصالة الحميمية أن يكون جسد الآخر أمامك وأن يكون جسدك أمامه، تستشعر به ويستشعر بك؛ هي تلك الإمكانية التي يُقال عنها في هذا السياق: «القدرة على الحضن أو التقبيل» وفي السياقاتٍ الأخرى: «القدرة على الركل والركض والربت والرمي.. إلى آخره» من الأفعال التي تتطلب وجود الذات الفاعلة مُتجسدةً في العالم الواقعي. فلا يمكن للزوج أن يحضن زوجته خلال المراسلة الإيروتيكية مهما بلغت درجة الحميمية والرغبة بينهما، لأن الوسط التقني للمراسلة لا يدعم القدرة على ذلك. هنا، يُرسم الحد الفاصل بين الشيء وامتداده؛ فلا تدعم مواقع التواصل بطبيعتها اللامتجسدة أصالة تجاربنا الافتراضية.
وبناءً عليه، يكون العالم الرقمي برمته عالمًا مُمتدًّا ومُتطلبًا لوجود مختلف، تكون فيه الذات الفاعلة «مُتَّصِلة» بالعالم؛ لأن الوجود في العالم الواقعي يكون عبر الجسد «بالتجسُّد»، في حين الوجود في العالم الرقمي يكون عبر الشبكة «بالاتصال». فالذات تُنزع من تجَسُّدها بمجرد اتصالها بالشبكة، لتمتد في فضاءات الإنترنت خلف حساباتها الشخصية مع بقاء جَسَدها ثابتًا خلف الشاشة. وهي بذلك تفقد شيئًا أساسيًّا من أصالة الوجود، ومعها تتولد مفارقة «القرب و البعد». فالقرية العالمية التي تقربني من صديقي في الطرف الآخر من العالم، لا تمكنني من أن أصافحه؛ وعلى الرغم من مشاهدتي له وهو يُعدّ القهوة، إلا أنني لا أشم رائحتها.
هنا نقول، وبعد تأخير مُبَرَّر، أن طرحنا هذا معنيٌّ بالجانب الفنومينولوجي، لا بالجانب التقني للممارسة الافتراضية؛ أي إن التطور التقني الذي سيُمكنني مستقبلًا – بطريقة أو بأخرى – من أن أشم رائحة قهوة افتراضية بالتزامن مع تلك التي يُعدّها صديقي في الطرف الآخر من العالم، ستبقى كخبرة أقل أصالة فينومينولوجيًّا؛ لأن هذه الأصالة تتطلب وجودِي المتجسِّد حيث يمكن للهواء أن ينقل رائحة القهوة من الكوب وإلى أنفي؛ أي أن أكون موجودًا حيث يُوجد الكوب في العالم الواقعي.
السلوك = الشخص x الموقف
عندما نقول إن العالم الرقمي أقلّ أصالةً من العالم الواقعي، يجب أن نطرح هنا سؤال «المدى» لكي يتسنى لنا استعياب حجم الفوارق بينهما؛ ولأن إجابة هذا السؤال تتطلب لغةً قادرةً على الوصف والشرح، نتحول من لغة الذات إلى لغة الموضوع، أي من التجارب الفنومينولوجية الذاتية إلى النماذج النفسية الموضوعية.
كيف يمكننا القيام بذلك؟
علينا أولًا أخذ (نموذجًا نفسيًّا للمعالجة السلوكية) ثم نجرده من القيمة التجسدية، لنرى ما إذا كان الناتج سلوكًا مختلفًا، وعليه نَصِف مدى الأصالة على أساس الاختلاف السلوكي.
وبعدِّ التجسد عاملًا أساسيًّا ومؤثرًا في السلوك والإدراك، نرى أن النموذج النفسي الأنسب لنا هو «نموذج معالجة التفاعل اللاخطي للشخص والموقف» لــ«غابريلا بلم Gabriela S. Blum» و «مانفريد شميت Manfred Schmitt». وهو نموذج قائم على الفرضية القائلة إن السلوك يُشَكَّل كنتيجة لتفاعل سمات الشخص وخصائص الموقف؛ مما يفسر لماذا يتصرف عشرة أشخاص بطرق مختلفة في الموقف نفسه، ولماذا يتصرف الشخص نفسه بعشر طرق مختلفة في مواقف عدة. وقد حُدِّدت أربعة عناصر سلوكية تكون تحت تأثير مباشر لتفاعلات محددة بين العناصر الشخصية والعناصر الموقفية.

«التَفعيل» كشرارة السلوك الأولى، تعتمد على نتيجة تفاعل «المطلَب» السلوكي للموقف، مع «الحد الأدنى» للقيام به عند الشخص.
مثال: عندما يتطلب الموقف تَصرُّفًا عاجِلًا، ويكون الحد الأدنى للقيام به عند الشخص مُنخفِضًا، فإن تفعيل السلوك سيتم في لمح البصر؛ كأن تضرب الأم مَن يحاول الاعتداء على طفلها.
«القابِليّة» على القيام بسلوكٍ ما، تعتمد على نتيجة تفاعل «البَدائِل» السلوكية المتعددة في الموقف، مع «نَزعة» الشخص بما تحمله من دوافعٍ ورغباتٍ وعادات.
مثال: كلما تعددت البَدائِل السلوكية الممكنة في الموقف، تتسع قابِليّة التصرف، وتصبح رهن نزعة الشخص الداخلية؛ كأن يُعنف المدير أحد عُماله المُقصرين بدلًا مِن معاقبته نظاميًا.
«الكبح» وتثبيط السلوك، يعتمد على نتيجة تفاعل «القيود» التي يفرضها الموقف، مع محاولات الشخص لـ«تَجنُّب» ما يترتب عليها.
مثال: ما يفرضه الموقف من قيود نظامية على السلوك، تدفع الشخص إلى تجنُّبها اتقاءً لما قد يترتب على ممارستها من عقوبات؛ كأن يلتزم المراهق بآداب الذوق العام اتقاءً للمخالفة.
«التَنَبّؤ» بسلوك الشخص، يعتمد على نتيجة تفاعل «انتِقائيّة» الموقف، مع مدى «تَقَلُّب» شخصيته.
مثال: تصعب القدرة على التنبؤ بسلوك الشخص كلما ازدادت تقلباته المزاجية، وانخفضت انتقائية الموقف؛ كأن يعاني المُحقق من صعوبة التنبؤ بسلوك المجرم السايكوباثي.
هنا، يتبيّن لنا بشكلٍ مُفصَّل الدور الأساس الذي يلعبه التَجَسُّد في تشكيل السلوك، وأننا بمجرد ما نسحب قيمته كما في حالة الاتصال بالشبكة وتصفح الإنترنت، فإن هذه المعالجة السلوكية ستتغير جوهريًّا لتنتج سلوكيات افتراضية مختلفة:

بمعنى، إن الطبيعة اللامتجسدة للعالم الرقمي لا تغير من سلوكياتنا فقط .. بل تغير معالجاتِنا السلوكية ككل!
فـ«الحد الأدنى» ظاهرة فيزيولوجية، أي إنها مرتبطة بالجسد وأعضائه المدرِكة لما حولها، وعندما تُنزع الذات الفاعلة من تجَسُّدها في حالة الاتصال، فإن هذا يؤثر في «تَفعيل» سلوكياتها. كما أن افتراضية المواقف في مواقع التواصل، تحد من «البدائل» السلوكية الممكنة، مما يؤثر بدوره في «قابِليّة» السلوك. والأهم من هذا وذاك، هو ما يفرضه الفضاء الافتراضي من «قيود» تكبل الجسد وتحرر امتداده ليفعل ما يشاء؛ إنها نعمة العالم الرقمي ونقمته.
فما يُعدّ سلوكًا مُريبًا في العالم الواقعي «كالترصد Stalking» على سبيل المثال، أصبح أقل ريبةً على مواقع التواصل، بسبب التغير على مستوى عنصر «الكبح» في المعالجة السلوكية؛ إذ إن القيود التي كانت تُصعّب من هذه الممارسة، وتدفع الشخص إلى تَجنُّبها، أصبحت على الإنترنت مسألةَ نقرة إصبع لا أكثر! وفي سياق أكثر إيجابيةً، نجد أن الفضاء الافتراضي يُخلّص الكثير من القيود النفسية للتواصل الاجتماعي، مما يساعدهم على الانخراط مع أقرانهم عبر الإنترنت، ويتيح لهم فرصةً لاكتشاف أنفسهم وتطويرها.
هذا الاستسهال في الممارسة الافتراضية هو سلاح ذو حدين، كما أنه يحمل شيئًا من خصائص مفارقة «القرب والبعد» إذ يمكن للمتنمر أن يؤذي شخصًا ما كما لو أنه قريبٌ منه، لكنه في الحقيقة يبعد عنه آلاف الكيلومترات؛ ويمكن للمُحِب أن يُغرق محبوبته عِشقًا كما لو أنها قريبةٌ منه، لكنها في الحقيقة تبعد عنه آلاف الكيلومترات. وفي الأحوال كلها، تكون الأصالةُ السلوكية هي الضحية. فكم مِن متنمر لن يقوى على ممارسة طيشه في الواقع، وكم من مُحِب يتمنى لو أن محبوبته لم تبقَ حَبيسة الشاشة.
هذه حقيقة لا مفر منها .. إن العالم الرقمي أقل أصالةً من العالم الواقعي.
وأنه في يومٍ ما .. على أجيال المواطنة الرقمية الهجرة إلى عالمنا الأصيل.
كلمات أخيرة
أن تكتب مقالًا عن مواقع التواصل الاجتماعي في عصر التسارع التقني، يعني أن تكتب آلاف الكلمات على مدى عدة أسابيع دون أن تذهب بعيدًا في هدفك. فالعالم الرقمي أكبر وأعقد من أن يُفهم هكذا؛ إنه دائم الحركة ودائم التغير، وهذا ما دفعني إلى التركيز في كتابتي على المفاهيم العامة بدلًا من المواقع نفسها. لقد أحضرت المِحراث، لكني لم أحرث الحقل؛ لأن هذا المجهود يفوق قدراتي ويتجاوز أفق نظرتي الفردية. أتمنى مِن أحد قُراء هذه المقالة أن يأخذ الأدوات المفاهيمية، ويقوم بالعمل الصعب؛ حينها فقط، نستطيع تسمية مواقع التواصل بمسمياتها.